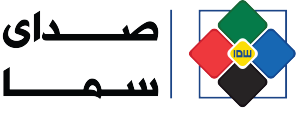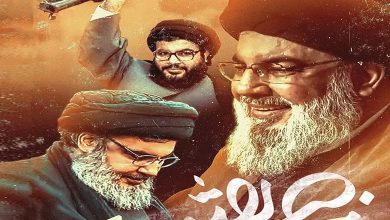الصراع ونهاية الديمقراطية الزائفة

 الدكتور سيد مهدي حسيني، الحاصل على دكتوراه في العلوم السياسية
الدكتور سيد مهدي حسيني، الحاصل على دكتوراه في العلوم السياسية
بحسب روايات ناقلي الأخبار ورواة الآثار، فإنّ من أهم وظائف التمثيل في نقل المعنى والمفهوم هو اختصار طريق الاستدلال في القضايا السياسية–الاقتصادية.
وعليه، فإنّ الباحثين في السياسة، من أجل تفسير وبيان ضرورة إعادة تنظيم الاقتصاد المختلّ، وبهدف تقديم حلول تحول دون «تجربة العيش في الفقر»، قد استعاروا تمثيل «عَرَض الطفل المريض» من سوق المعاني في مجال العلاج الأسري.
فبعض الأعراض تتحول في الواقع إلى ما يشبه الحُكم المنظِّم لنظام الأسرة؛ إذ يقوم الطفل المريض، من خلال تحويل انتباه الأسرة بعيدًا عن خلافات أكثر جوهرية «ليس من السهل حلّها»، بدور تحييد النزاع.
(غولدينغ، غولدينغ، العلاج الأسري، ص 479)
ولا شكّ أنّ الجدل والنزاع جزء لا يتجزأ من الحياة. ويقع الصراع (Conflict) عندما يشعر فردٌ ما بأنّ شخصًا آخر يعيق وصوله إلى احتياجاته الأساسية في الحياة.
وفي الأصل، فإنّ احتكاك الآراء، ما دام لا ينزلق إلى العنف، يُعدّ أحد شروط النموّ الاجتماعي.
غير أنّ الاقتصاد غير المتوازن واضطراب بيئة الأعمال، إضافةً إلى تأثيرهما العميق في الأسرة وبقاء الأجيال، يمكن أن يؤدّيا إلى تحوّل الصراع إلى عنف.
ولهذا السبب بالذات، ينبغي في عملية التحليل السوسيولوجي لقضايا المجتمع المعاصر التأكيد على ضرورة إنهاء الصراع الحيدري–النعمتـي / السياسي–الفئوي، والتنبه إلى نهاية الديمقراطية الزائفة.
في الوقت الراهن، فإنّ تعاليم «كنيسة غوغل المنحطّة» لا تستند بأيّ وجه إلى الفضائل المسيحية المتمثلة في الإيمان، والرجاء، والمحبة، بل تقوم على حلم شيطاني قوامه الإحباط، والخوف، والتشاؤم.
ومن ثمّ، فإنّ إظهار التمييز الجوهري بين الرؤية الدينية المستندة إلى قراءة الأديان الإبراهيمية (ع)، وبين الأيديولوجيا الحاسوبية القائمة على تعاليم كنيسة غوغل، يمكن أن يبعث الأمل في جزء من الجيل الجديد بانتعاش الأعمال ومستقبل أكثر إشراقًا.
ولا سيما أنّ خروج قطار العمل والدخل القائم على المنهج والرؤية الدينية عن سكّته، واختلال توازنه—إن كان نتيجة التساهل أو التخلّي عن التعاليم الدينية—فإنّه في ظروف العصر الرقمي المضطرب قد يُسقط الجيل الجديد في فخّ كنيسة غوغل؛
ذلك أنّ عقله الحيوي مليء بالأسئلة، ومحركات البحث تقدّم لتلك الأسئلة إجابات انتقائية منسجمة مع أيديولوجيا كنيسة غوغل.
أي إنّها:
«ثمرة جُنيت بكلفة باهظة من شجرة المعرفة، وهي في طور تدمير البراءة الماورائية».
(كار؛ ماذا يفعل الإنترنت بأدمغتنا؟، ص 163)
ومع بداية الربع الثاني من القرن الحادي والعشرين، والتسارع الشديد في التحوّل الرقمي، فإنّ شرح:
«كيف تدمّر الديمقراطية نفسها، وكيف انتهى قرن الديمقراطية»،
إلى جانب التبيين العلمي لكفاءات خطاب الإسلام السياسي الفقهي، يُعدّ حلًا سريع الأثر، ويمكنه أن يمنع تفلّت نبات اللبلاب من إيواننا، واندفاعه لاحتضان أشجار بعيدة.
غير أنّ الخطر يتعاظم إذا ما أفضت حيلة العدوّ الخبيث الجديدة والمعقّدة—المتمثّلة في انفلات الأسعار، و«دولرة أرزاق الطبقات المستضعفة»، وخلق شبه أزمة مدمّرة في الغذاء والكساء والمسكن—إلى واقع ملموس.
ومن الواضح أنّ المكر الجديد لـ«مؤسسة غسل الأدمغة التابعة للديكتاتور–الرقمي» يتمثل في زرع الشك في فكر ودوافع شريحة واسعة من الجيل الناشئ تجاه المنهج والرؤية الاقتصادية الإسلامية.
فالمنظومة الرقمية تعرض حياة متلاطمة في «مدينة الفرجة» ومهد الديمقراطية الزائفة، عبر قصص ذات طبيعة واقعية إلى حدّ يُذهل العقل ويعجز الفهم.
ومن أجل إضفاء المصداقية على الصور الملوّنة الزاهية التي «تبدو أكثر حياةً من الحياة نفسها»، جرى منذ عام 1940 وإلى اليوم بحثٌ مستمر، وإنفاقٌ واسع، وعملٌ عميق دون انقطاع.
وبعد عقدٍ من ذلك، صرّح مارتن هايدغر، إثر مشاهدته هذا الجهد الجادّ والتكلفة الباهظة، بأنّ:
«الموجة الصاعدة للثورة التكنولوجية قد تصبح جذّابة وساحرة ومغرية إلى حدٍّ يُفضي إلى أن يغدو التفكير الحسابي يومًا ما الطريقة الوحيدة المقبولة والممارسة في التفكير».
ومع تحقّق ذلك، كان الباحثون في السياسة خلال الربع الأول من القرن الحالي يقيّمون كيفية استفادة الدولة الإلكترونية من الابتكار الرقمي، ومستقبل القوة السياسية والاقتصادية، غالبًا من خلال قراءة جوزيف ناي حول مستقبل القوة.
فالقوة الناعمة في العالم الحديث، وتحت مظلة القوة العسكرية الحاسمة، اتجهت في وادي السيليكون إلى التأثير عبر:
«القوة الذكية / المزيج الاستراتيجي من القوة الصلبة والناعمة»،
حتى جرى تحويل الهاتف المحمول إلى قمر صناعي قزم قادر على إنجاز عمل العمالقة.
إنّ فهم لماذا وكيف نشأت هذه القوة، وكيف تحدّت السلطة التقليدية للدولة، يُعدّ إحدى نقاط التحوّل الكبرى في التاريخ المعاصر، وعاملًا بالغ التأثير في انحراف الاقتصاد عن مساره.
وبالتوازي مع الدراسات الرامية إلى خلق هذه الكائنات العجيبة والمخلوقات الغريبة، والتي بدأت في أوائل أربعينيات القرن العشرين، شهد المجتمع الإيراني في عام 1320هـ.ش:
ضجيجًا وهتافات لجماهير اصطفت على الطريق الملكي، تصفّق لأمير ناشئ،
وانتشار مظاهر اللهو والترف والرقص، ممّا مهّد الأرضية لخلافات جوهرية أصبح «حلّها دون الاتكاء على التعاليم الدينية مثيرًا للنزاع».
وهي فترة كان فيها الشاه يسيطر على قنوات الوصول إلى الثروة، وهي عملية أفضت عبر الإغواء والتلاعب إلى نتائج مدمّرة في السياسة الإيرانية.
كما أشار مارفن زونيس:
«في إيران، أول من ينتهك حقوق الناس هو الدولة نفسها، وإنّ المؤامرة والفساد—وهما أمّ كل الشرور—عاملان ملازمان دائمًا لحياة الناس. وكلاهما متجذّر في انعدام الأمن، وكلاهما يغذّي ذلك الانعدام، حتى أصبح حلّ هذه المشكلات أشبه باللغز».
(سيكولوجية النخب السياسية في إيران، ص 353)
وقد عرض الشعب الإيراني العظيم مشكلاته على «پيرِ مغان» الذي كان اسمه الراية ذاتها. ذلك العائد من السفر، الذي قاربت شخصيته الأسطورة، أكّد الرأي في حلّ اللغز، ومن خلال تأسيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية جرى الابتعاد كليًا عن النفوذ المفسد للمادية الغربية، وبصورة خاصة عن نفوذ الشيطان الأكبر، الولايات المتحدة.
(هيوود؛ السياسة، ص 175)
واليوم، يتحرّك ذلك الشيطان الماكر بسرعة الضوء نحو تجميع ظلالٍ من ظلمةٍ شاملة، ويؤدّي—بحسب سخرية «أصحاب غريزة الفكاهة»—واجباته في حماية أرواح وأموال الناس «خارج أمريكا» على أكمل وجه!
وفيما يتعلّق بالمجتمع والثقافة (العالم الاجتماعي) في المجال الخصيب لإيران، فقد بدأ التخطيط للمؤامرة والفساد منذ صباح
February 11, 1979 المشرق، ولا يزال هذا المسار مستمرًا بكامل زخمه في مسرح الديجيتالية الشيطاني.
غير أنّ الشباب الإيراني الواعي، الذكي، المثقف، وذو البصيرة، سيُفشل هذه المرّة أيضًا مخططات وأحلام الشعوذة الإعلامية، ولا سيما حلم «الأمير الجاهل» الذي يُراد به تسكين ألم الغلاء وهمّ الخبز.
ولا يخفى أنّ:
«التكنولوجيا، بوصفها نظامًا قويًا لتعقيل الافتراضات، تفرض نفسها في صمت».
ولهذا ينبغي تنمية نمط من التفكير يكون في آنٍ واحد نقديًا تجاه نزعة الهيمنة التكنولوجية، وقادرًا على معالجة العواقب غير المفكّر فيها لمنتج وادي السيليكون، أي الهاتف–القمر الصناعي.
وإلا، ففي هذه الأيام ما بعد الحروب، ومع تدهور الأوضاع المعيشية للفئات المستضعفة، فإنّ «شعار الموت للسياسة سيجد أنصارًا كُثرًا».
ومن التوقّعات المشروعة من كليات العلوم السياسية أن تعلن، بالدليل والبرهان، أنّ الحكم القائم على:
«الكلمة اليونانية الغامضة ديموس (الشعب) وكراسيا (السلطة) يسلب السيطرة على الحكم من المختصين والخبراء ويسلّمها إلى الديماغوجيين».
(مكلين؛ معجم العلوم السياسية، ص 259)
حتى إنّ أفلاطون وأرسطو أبديا أسفهما حيال ذلك؛
فـ«أرسطو، أبو علم السياسة، أدان الديمقراطية بوصفها شكلًا فاسدًا ومضللًا للحكم، في حين وصفها أستاذه أفلاطون بأنها حكم الجهل».
وعلى أي حال، فإنّ هذا اللغز وأسلوب التضليل الجماهيري «موجود منذ زمنٍ لا تُدرك بدايته في المجتمع البشري»، ومن أوجه قصوره:
«الكلفة العالية، التعليم الزائف، إساءة استخدام مبدأ المساواة، عبثية الحديث عن حكم الأكثرية… إذ يقوم الديماغوجيون الأذكياء، عبر التحريف والمبالغة وكلام جميل لكنه غالبًا فارغ، بدفع الناس إلى التصويت لهذا أو ذاك وخداعهم».
النتيجة:
إنّ استمرار الصراع الحيدري–النعمتـي، وبقاء ماهية الديمقراطية الزائفة مجهولة، قد يوسّع ظلّ أيديولوجيا الحاسوب على مناهج وأساليب العيش الديني؛ وعندها تقوم الديجيتالية بـ«سلب الحكم من الخبراء وتسليمه إلى عوامّ مضلَّلين».
إنّ تمثيلاتٍ من قبيل الطفل المريض، والعيش الفقير، وتنظيم نظام الأسرة، واختلال الاقتصاد واضطراب الأعمال… كلّها تُبرز أكثر فأكثر ضرورة المعالجة العاجلة.
وفي هذا السياق، أدخل المفكرون السياسيون المخضرمون مفهوم المصالحة الوطنية إلى الأدبيات السياسية للخروج من مثل هذه الظروف الحرجة.
حقًا، وبهذه المعادلة السياسية، يمكن إبطال الحلم الشيطاني للعدوّ سيّئ النيّة.