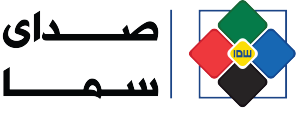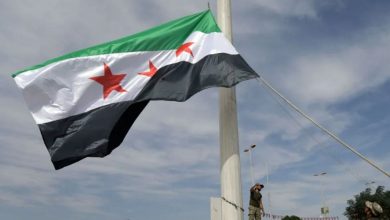الجندية لله، لدى الأنصار في اليمن المعنى الحقيقي لقوتهم

 مجاهد الصريمي صنعاء:
مجاهد الصريمي صنعاء:
كانت ولا تزال قوة أنصار الله في اليمن، قائمةً على الأسس والمبادئ الإيمانية، وما بقية المظاهر إلا نتيجة لها.
ولكي تتضح المسألة، لا بد من معرفة مفهوم الأنصار عن معنى الجندية لله، وذلك من خلال ما قدمه الشهيد القائد المؤسس حسين بدر الدين (ر) وهو يتحدث عن دعاء مكارم الأخلاق للإمام زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، إذ يقول الشهيد القائد (رضوان ربي عليه): إن في هذا الدعاء المشتمل على أشياء كثيرة لا بد للإنسان أن يرجع إلى الله ليطلبها منه وليرجو الهداية إليها منه وحده، كون الهداية لا يملكها إلا الله وحده سبحانه، فليست آلية برمجية معينة يمكن لنا التزامها لتتحقق لنا الهداية، بل لا بد من الرجوع إلى الله لنطلبها منه، لا بد من الدعاء له أن يهدينا، أن يمنحنا الهداية والاستقامة والثبات والسداد في العمل والقول، في الكلمة والخطوة والموقف، كما أن هنالك أعمالاً مهمة وجوانب كثيرة نحن بحاجة الوصول إليها لما لها من أهمية في حياتنا الدنيا وفي الآخرة، فهذا زين العابدين وسيد الساجدين على الرغم مما قد بلغه في زهده وتقواه وورعه وجهاده وإحسانه، لايزال يطلب من الله أن يبلغ بإيمانه أكمل الإيمان، ولم يكتف بما وصل إليه ولم يكتنفه الغرور، وهذا كما يقول الشهيد القائد (عليه السلام) هو مطلب مهم وغاية تستحق من الإنسان السعي لنيلها، وذلك أن يكون دائم الطلب من الله أن يبلغ بإيمانه أكمل الإيمان.
ومما سبق يمكن الخروج بجملة من الفوائد التي هي بمثابة معالم وعناصر تصاغ بموجبها بنية وكيان المجتمع والفرد المؤمن، وهي:
1 ـ الارتباط بالله ودوام الرجوع إليه والطلب الحثيث منه بالهداية.
2 ـ عدم الركون إلى النفس والاكتفاء بما قد سبق أن قدمنا، والوقوف عند خط معين، لأن هذا باب لدخول إبليس والاصطباغ بصبغته والاتصاف بصفاته التي هي الغرور والتكبر.
3 ـ دوام السؤال لله أن نبلغ بإيماننا أكمل الإيمان، لأن ذلك مطلب مهم وغاية تستحق الحرص عليها والسعي لنيلها.
ثم يبين (سلام الله عليه) مصدر التعرف على الإيمان وعن المؤمنين وعن كمال الإيمان وهو القرآن الكريم، وبهذا نستشف وعي الشهيد القائد (عليه السلام) بأن كل المفاهيم قد تعرضت للتشويه والتزييف، لذلك يجب العودة للتعرف عليها من خلال كتاب الله باعتباره مصاناً من الزيف ومحاطاً بعناية الله وحفظه فلا تطاله يد التحريف.
يحذر الشهيد القائد (رضوان الله عليه) من أن تتملكنا رغبة الاكتفاء بما نحن عليه، وأن نحبس أنفسنا في وسط دائرة نضع حولها خطوطاً حمراء لا نتجاوزها، وخصوصاً في جانب التربية الروحية تربية النفس من خلال ترسيخ الجوانب الإيمانية، لأن من يرضى لنفسه أن تظل عند مستوى معين في مسألة الارتقاء الإيماني، هو ذلك الذي يقبل على نفسه أن يكون تحت، بحيث رسم لنفسه خطاً معيناً لا يتجاوزه، ورضي بأن يبقى دون ما عليه أولياء الله، لأن الإنسان المؤمن هو جندي من جنود الله الذي له ميدان تدريب وميدان ترويض ليكون جندياً فاعلاً محصوراً على التحرك في ساحتين؛ ساحة العمل التي لا بد أن تتداخل مع ساحة النفس لتشكلا ساحة واحدة، فكلما ترسخ الإيمان في النفس تمكن الإنسان من الصعود والترقي في مدارج وسلالم الكمال الإيماني الذي كلما ارتقينا في مدارج الوصول إلى نقطة بلوغ الكمال فيه كان لذلك أثر ومردود على الجانب العملي، بحيث نصبح أكثر فاعلية وأحسن أداء وأكثر التزاماً.
وبما أن المؤمن جندي من جنود الله لا بد عليه من الفهم لآلية تحركه في ميادين الرضى لله سبحانه، من هنا يحرص الشهيد القائد على تقريب الصورة من ذهنيتنا وتحريك مفهوم الجندية لله في قرارات نفوسنا، بحيث ضرب لنا مثلاً من الواقع المعاش لدى الدول والأنظمة التي تختار من داخل جيشها مجاميع وفرقاً معينة تدربها تدريبات خاصة، وتدريبات مكثفة لتكون قادرة على القيام بمهام صعبة ومهام شاقة، وتلك المهام التي هي في ذهن رئيس أو ملك هي أقل بكثير مما هو بذهن المؤمن، نظراً لاختلاف المهام واختلاف ميادين العمل لكلا الجنديين.
فجندي الدولة أو النظام يقتصر عمله على تنفيذ مهام كلها حركة، قفزة من هنا إلى هناك، وباختصار فإن مهامه وأعماله وميدان حركته محدودة بحدود جسمه، ومحدودة بحدود ذهنية النظام الذي يتبعه، لكن جندي الله مهامه واسعة ينبغي عليه ترويض نفسه لأدائها، لأنها تتطلب لإنجاحها نفساً راقية، وروحية نقية، ووعياً عالياً، وإيماناً راسخاً لا يتزلزل، وإرادة قوية، وعزماً مستمراً، وهمة لا تلين، لأن مهامه هي مهام تربوية، وكذلك تثقيفية وأيضاً جهادية.
وهي مهام تتحرك في إطار يشمل كل مقتضيات الوعي بالواقع والفهم لكل مجرياته والقدرة على تبيين كل ما يهم الناس في محيط عمله وساحة قيامه بدوره، فإذا ما انطلق في ميدان التوعية والتبيين للناس أمور دينهم وترسيخ معانيه في قلوبهم كان القادر من خلال حديثه عن دين الله أن يرسخ العظمة والجلال لهذا الدين في نفوس الآخرين.
وهنا يوضح (رضوان الله عليه) قيمة وأهمية وعظمة مسؤولية جندي الله التي يقتضي أداؤها بالشكل المطلوب التزام أسمى السبل وأنبل وأشرف الدوافع بحيث إنه ينطلق بعمله التوعوي والتثقيفي والجهادي والتربوي وفي كل مجال من مجالات الرضى لله بدافع الحب للآخرين والحرص عليهم والرغبة في هدايتهم والرعاية لأمورهم والمعرفة لواقعهم والحفاظ على كرامتهم، إذ يتوجه (سلام الله عليه) لكل عامل في ساحة الفكر والثقافة وميدان الكلمة بعبارات مفعمة بحب الناس، تلك العبارات تحمل طابعاً بريدياً لذلك القلب الذي خرجت منه، إذ يقول لكل العاملين بأن ميدان عملهم نفس الإنسان وليس بيته لتنهبوه، وليس جدار بيته لتقفزوا فوقه أو تتسلقوه.
من هنا يتضح المساران ويتمايز الجنديان، فجندي للدنيا وعبيدها جعل من نفسه سوطاً وأداة تدميرية بيد زعيم أو ملك، وجندي لله عاش صدق عبوديته له سبحانه من خلال حبه لعباده وحرصه عليهم وعمله الذي يعود بالخير لهم ويصون حرياتهم وحقوقهم وكرامتهم، ولأن ميدان عمله هو النفس الإنسانية التي ليست واحداً ولا اثنين، بل نفوس كل البشر، فهو لا يحبس نفسه في بوتقة المناطقية والمذهبية ولا يحشر نفسه في قمقم القطرية والقومية، بل يتحرك كمعني بالعالمين لأنه جندي لله رب العالمين.
كما أن الشهيد القائد يؤكد على ضرورة أن يسعى المؤمن دائماً في ترويض نفسه وتطوير أساليبه على أساس تربوي إيماني، وفي ظل دوافع إيمانية ضمن إطار الانتماء الإيماني أيضاً ليتمكن من تقديم الحق بشكل قوي وقادر على أن يزهق الباطل في داخل النفوس، لأنه متى ما تمكنا من إزهاق الباطل في دواخل النفوس تم لنا إزهاقه في واقع الحياة «إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم»، فمتى ما صلح داخل الإنسان صلح محيطه، وعليه يتبين أن كل خلل في واقع الناس ومعاشهم مرده إلى خلل داخل نفوسهم، وهذا لا يعفينا من المسؤولية، بل يحملنا تبعة كل ذلك مما يحتم علينا المزيد من السعي لتحصين النفوس التي يحيط بها الخلل من كل الجهات والعمل على إصلاحها ونسف كل ما علق بها من الباطل.
وعليه فقد تبين لنا أن الخلل مكمنه في النفوس، فمتى ما صلحت صلح واقعها، وهنا يقدم لنا الشهيد القائد (عليه السلام) ما تتطلبه مهمة جندي الله التي تعنى بالنفوس بحيث يقرر بالاستناد إلى القرآن الكريم بأن المؤمن لا بد له دائماً من الحرص على أن يرتقي ليكون جديراً بهذه المهمة التي تحتاج للنهوض بها عملية ارتقاء إلى درجة يستطيع هذا المؤمن من خلالها أن يزهق الباطل من النفوس.
ولم يقدم الشهيد القائد (عليه السلام) هذه المهام والمبادئ التي لا بد للمؤمنين أن يطلبوا من الله أن يهديهم لها وأن يبلغ بإيمانهم أكمل الإيمان لتستقيم خطاهم في ساحة الأداء لمهام ومسؤوليات هذه المبادئ التي لا يصدق الانتماء الإيماني إلا بها، لم يقدمها بشكل انفعالي تجريدي، ولم تكن مراسيم صادرة عن شخص يتحدث ويخاطب الناس من برجه العاجي، كما هو حال الكثير م من يتعاملون مع الفكر والثقافة والكلمة ومجالات حركتها والتربية وميادينها كمهن وكصنائع لتحقيق الرفاه ولجلب الأرباح، بل قدمها وهو يعي صعوبة الواقع ويدرك طبيعة التحديات. قدمها وهو يعمل ويسعى وبكل ما لديه بكل كيانه على أن يبني العاملين في سبيل الله في روحيتهم وتفكيرهم وقوتهم ومنطقهم وسلوكهم وعباداتهم ومعرفتهم لربهم، ومن تم له جانب المعرفة لله ربه تم له جانب المعرفة بعدوه، لأن كل من هو عدو لله هو عدو لجندي الله، وكل من هو ولي لله كان وبدون شك ولياً لهذا الجندي الذي يحب في الله ويعادي فيه ويعطي له ويمنع كذلك من أجله، وعليه فقد خاطب كل من يعيش العبودية لله ويتجند تحت راية كلمة الإخلاص بالوحدانية له سبحانه ويلتزم بمقتضى الإيمان بربه الذي يصدق عليه ويعبر عن مستوى تمثله له كإيمان كامل وتام لا تشوبه شائبة بواقعه العملي الذي بلغ فيه مرتبة الخلوص لله فهو يعمل في سبيل الله.
لقد بين له الشهيد القائد (عليه السلام) وبين لكل من يريد أن يصبح جندياً لله ويعمل في سبيله، أن طريق السير في ما يرضي الله ليست مفروشة بالورود، بل سيرى كل من عزم السير على هذه الطريق الأشياء الكثيرة التي ستعترض طريقه، والتي يسعى المبطلون من خلالها لإسقاطه وإعادته إلى الخانة الصفرية وإدخاله في قالب العدم، فهي متنوعة بتنوع من يستهدفهم العدو بها، وكذلك تتعدد مبانيها وتتنوع أساليبها، فقد تكون دعايات باطلة وقد تكون اختلاقات وتشويهات وقد تكون محاولات في زرع الشك والريب في نفس العامل لله تجاه منهجه الذي يتحرك بناء عليه أو في قادته أو في العاملين معه، بل سيسعى المبطلون لجعل كل واحد يشك بنفسه، وهم فوق هذا يعملون بالترغيب وبالترهيب على أن ينفرط العقد الذي ينتظم به العاملون في سبيل الله ليصبح كل واحد منهم في فلك خاص به لا يجد في مداره سواه ولا ينظر بمستوى أكثر من موضع قدميه.
لكن هذا الواقع الذي يجد العاملون لله أنفسهم ملزمين بمواجهته والعمل على تغييره وذلك في طريق الإصلاح لكل مفسدة فيه، فهم -وهذا حالهم- لا تزيدهم التحديات والمخاطر والصعوبات إلا قوة وتصميماً وصلابة في الثبات على موقفهم، فكل ما عمل المبطلون على زرعه كشوك في دروبهم ونشروه كجمر يلظي أقدامهم ونصبوه ليكون سبيلاً لتعثرهم ما هو إلا امتحان يمتحن السائرون في خط الله وعلى صراطه، أنفسهم ليتبين لهم مدى التصديق بتلك القناعات والمبادئ والقيم التي يدعون الناس لتمثلها، فلا وهن في قاموسهم ولا ضعف يحتمل العمل به ضمن خياراتهم، ولا استكانة قد ترمي بظلالها على ساحتهم، لأن ما يعملون بصدده ويسعون لجعله صورة يصاغ بموجبها واقع البشرية بكلها هو مسؤولية نابعة من الداخل وليست مفروضة من الخارج، صادرة عن فكر وإحساس ومعبرة عن عقيدة، ولذلك فكل صعوبة، كل تحدٍ، كل ألم يلاقونه ما هو إلا النار التي تكشف للعيان أصالة معدنهم وصدق التزامهم وعظمة صبرهم وكمال نهجهم، فهم كلما أحاط بهم تراجع أو حصل لهم انكسار أو حلت بهم هزيمة علموا أن ذلك من عند أنفسهم، وأنه سبب ناتج عن تقصيرهم وإسرافهم وارتكابهم للمعاصي وركونهم إلى نفوسهم وتفريطهم بجنب الله، فيسارعون للنهوض من غفلتهم وينطلقون بسرعة البرق ليقدموا بين يدي ربهم تقريراً تضمن اعترافهم بما بدر منهم، طالبين من ربهم المغفرة والرحمة بصدق توبة وإنابة، مستمدين وسائلين ربهم أن يثبت أقدامهم وينصرهم على عدوهم «وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين»، لأنهم يعرفون أن الحق متى ما قُدم بكماله وجاذبيته وجماله ووضوحه في أي ميدان من ميادين التزامه والعمل به سواء كان ذلك في ساحة الفكرة والكلمة أو في ساحة الموقف والسيف والرصاصة، فإنه كفيل بإزهاق الباطل، لكن بشرط أن يؤهل العاملون فيظله أنفسهم لتجسيده وتقديمه دون نقص فالباطل زهوق.
ثم من قال إن الحق ضعيف وبأن أهل الحق مستضعفون فإنه يفتري على الله ويكذب بكتاب ربنا سبحانه «وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً»، ولو ترك المجال لمثل الإمام علي (عليه السلام) أن يقدم الحق منذ التحاق النبي بالرفيق الأعلى لكان حال المسلمين مختلفاً بكثير عما هو عليه من ذلة وانحطاط وتخلف وانحراف، لكن كلف بتقديم الحق من يعتريهم النقص فساد النقص في كل شيء.
إن الحق بقدر ما له من مكانة وقيمة كبيرة يحتاج كذلك أن يكون من يتمثله ويدعو إليه ويحمل المسؤولية في تثبيت قواعده في واقع الحياة، وترسيخ مبادئه في نفوس الناس، إلى درجة أن تصاغ قناعاتهم على أساسه وتضبط سلوكياتهم بضوابطه، أن يكون بمستوى هذا الحق قادراً على أن يقدمه للآخرين بصورته الحقيقية وبكل ما يحتويه من جلال وكمال وجاذبية وشمولية، وهذه الميزات والسمات ليس بالأمر المتاح أن ينالها كل أحد من خلال التعلم والاطلاع ومن خلال الاقتصار على قدراته الذاتية وقابلياته في جانب الفهم والإدراك وسرعة البديهة وقدرة الاستنباط، وكذلك الربط والاستنطاق، بل لا بد له أن يعرف الحق أولاً بكل ما له من طرائق وجوانب ومعالم وأعلام، وأن يحمل مهما قد قطع من شوط في ميدان معرفة الحق روحية الأنبياء (عليهم السلام)، وهي أن يسعى للمزيد والاستزادة أكثر، فقد خاطب الله في كتابه نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «وقل رب زدني علماً»، ثم يسعى ثانياً لمعرفة كيفية التقديم لهذا الحق.
وهذه الكيفية لا يمكن اكتسابها بالخبرة ويستحيل نيلها بالممارسة والتجربة، بل لا بد من الرجوع إلى الله لطلبها منه سبحانه، فهذا نبي الله موسى عليه السلام يطلب من الله أن يعطيه ويمنحه مستلزمات وشروط وعوامل النجاح التي من خلالها يستطيع أن يقدم الحق الذي عرفه الله سبحانه به وكلفه بحمله وألزمه بتبليغه وتقديمه إلى فرعون، إذ يدعو الله بهذا الدعاء الذي تضمنه القرآن الكريم: «رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدةً من لساني يفقهوا قولي». وهكذا هو الأمر لمن يدعو بدعوة الأنبياء ويجسد امتداد الرسالة ويسعى لنيل رضى الله ويعيش العبودية المطلقة له تبارك وتعالى، ثم يعرف ثالثاً من هو الذي بإمكانه وباستطاعته أن يقدم الحق، سيما في زمن عم الباطل فيه وساد، زمنٍ ظهر الفساد فيه واتسع واستشرى.
فهل هناك مادة علمية يمكن للإنسان أن يدرسها ويستوعب كل ما تحتويه فيكون بعد هضمها قادراً على أن يقدم الحق؟
وهنا يعرفنا الشهيد القائد (رضي الله عنه) من هو الذي بإمكانه أن يقدم الحق بطريقة تجعله قادراً على أن يزهق الباطل. إنه ذلك الذي يطلب دائماً من الله أن يبلغ بإيمانه أكمل الإيمان حتى وإن كنت متعبداً لله مكتفياً بتأدية العبادات من صلاة وزكاة وحج وصوم ونوافل ومستحبات، فإن ذلك لا يكفي، لأنك لم تصل بعد، إذ لا بد لهذه العبادات أن تتمظهر حقيقتها بواقعك وتبرز مخرجاتها من خلال عملك وسلوكك وتحركاتك، لذلك يجب أن تكون وعلى الدوام كثير الإلحاح في دعائك لله أن يبلغ بإيمانك أكمل الإيمان، ودعاؤك لا بد له أن يكون مصحوباً بحركة دؤوبة للبحث عما يبلغك هذه المكانة، ويوصلك لهذه المنزلة، وذلك يحتم عليك البحث عن أي جلسة أو محاضرة أو أي وسيلة لتحقيق ما تريد ونيل ما ترجو من كمال في جانب انتمائك الإيماني، إذ لا بد له أن يتحقق فيك، ويتجلى في قناعاتك وتوجهاتك ونظرتك للأشياء وحكمك عليها، واتخاذك للمواقف منها.
وهذا يجعلك تدرك أنك لاتزال بحاجة لأن تسمع وتفهم وتعرف، لأن هنالك أعداداً كبيرة من الناس الذين يدعون الإيمان بحيث يجدون أنفسهم لم يعودوا بحاجة إلى من يذكرهم ولم يعد هناك شيء لم يطلعوا عليه فقد أصبح لديهم في قرارات أنفسهم أنهم قد سمعوا وعلموا واستوعبوا بما فيه الكفاية، وهؤلاء حين يتحركون لمحاربة الباطل ويعملون على إزهاقه فإنهم لا يستطيعون ولو إزهاق جزء منه في واقع الحياة، ناهيك عن أن يتمكنوا من إزهاقه من دواخل النفوس.
إن مشكلتنا في ميدان العمل لتبليغ الحق سواءً في مجال الفكر أو الثقافة أو الإعلام، أننا نكتفي من كل شيء بالشكليات وننكب فقط على ما يحقق لنا مكانة وقيمة لدى الآخرين، كأن يتجه أحدنا للدراسات العليا لينال شهادة ما تكسبه هذه الشهادة لقباً معيناً أو اسماً معيناً كأن يصير العلامة أو الدكتور أو الخبير العسكري أو عالم الاقتصاد أو عالم الاجتماع أو غير ذلك، لكن هل بمقدور هؤلاء أن يغيروا شيئاً في واقع الحياة؟
إن الجواب بنعم ضربٌ من الجنون باعتبار الواقع يقول إن الذين استطاعوا ويستطيعون التغيير للواقع هم أولئك الذين يطلبون من الله أن يبلغ بإيمانهم أكمل الإيمان، وتجلى هذا الكمال بعملهم وثباتهم وقدرتهم في مواجهة التحديات، فهم يتحركون بعزم راسخ وإرادة قوية لا تلين وهمة لا تضعف، وها نحن نرى ذلك بيناً في كل الجبهات ونعيشه واقعاً في ثورتنا وقيادتنا العظيمة التي استطاعت أن تغير الواقع ليس فقط على مستوى المحيط الجغرافي في اليمن، بل على مستوى المنطقة والعالم.
إن ما يجب أن نعرفه كمؤمنين أن انتماءنا للإيمان يعني أننا نمتلك الحق، فإذا لم يكن هذا الحق قادراً على إزهاق الباطل من واقع حياتنا ودواخل النفوس فإننا لا نمتلك الحق، أي لم نصل بعد إلى المستوى الذي يجعلنا جديرين بشرف الانتماء الإيماني.
وهكذا كان من ظنوا أنفسهم أنهم في سعيهم سينالون الربح والفلاح فأحاطت بهم ضلل الخيبة وابتلعتهم رمال الخسران، لأنهم حين انطلقوا لم يكونوا على وعي كامل بما لديهم، بل كانوا يسيرون وراء الظن، وكانوا لا يكلفون أنفسهم الالتزام بالحق كله، والتمثل للدين كله، لذلك خسروا «قل هل أنبؤكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً»، وعليه كي لا نصل إلى هاوية الخسران علينا التزود بموجبات الفوز ومحققات الربح في الدارين.
من هم الذين يجنون على الأمة؟ إنهم أولئك الذين يتحركون بأعداد كبيرة تحت مبرر الادعاء بالانتماء إلى الإيمان، وباسم محاربة الباطل والدفاع عن الحق، ولكنهم لم يتزودوا لرحلتهم تلك بالزاد الكافي، ولم تكن انطلاقتهم مبنية على عمق وتجذر معرفي تمتلئُ به قلوبهم، وتضج به مشاعرهم وتطمئن إليه نفوسهم، لذلك سقطوا، وذابوا، واختفوا، وانقشعوا وتبخروا، فلم يكن الادعاء صادقاً بحيث لو كان هذا الإيمان حقيقياً لظهرت علائمه في تقديمهم للحق ومقدرتهم على إزهاق الباطل، لكنهم فشلوا في أن يزهقوا جزءاً من كثير الباطل، ناهيك عن أن يتمكنوا من تقديم الحق، بل وصل بهم الحال إلى نقطة كاد فيها الحق الذي لديهم أن يزهق ويتلاشى ويذوب وينعدم.. لماذا؟ لأنهم رسموا لأنفسهم خطاً لا يتجاوزوه، بل جعلوا بينهم وبين الهداية حاجزاً وسوراً حال بينهم وبين إمكانات الارتقاء الذي يحتاج إلى السعي الحثيث في الازدياد في المعرفة والسعي في تحقيق المزيد من الهدى، فإن من يريد أن تكون حركته فاعلة وانطلاقته مؤثرة ومثمرة في نتائجها التي تظهر وتنعكس في واقع الحياة وواقع الناس لا يضع لنفسه حداً لا يتجاوزه، ولا يحدد لخطواته مقاماً تقف عنده ولا تتعداه، باعتبار أنه جندي لله ومملوك له سبحانه بدأ منه وسينتهي إليه، وما بين المبدأ والمعاد نجد طريق السير التي تتطلب الحرص على ما ينفعنا من خلال محاولة الاستفادة من كل ما نسمع من هدى الله والمداومة على ذكره والطلب منه أن يهدينا وملازمة الذاكرين له، والعمل على قراءة كتاب الله بوعي وتدبر وتفهم، إلى جانب الحرص على قراءة صفحات هذا الكون في مظاهره وظواهره، وكذلك التأمل في الأحداث وفي حياة وأعمال وأحوال الناس من حولنا، فإن ذلك كما يقول الشهيد القائد: ما أكثر مايصنع من إيمان.. وهكذا نجد أن من أهم ما يجب الوعي به والاستفادة منه بعد كتاب الله هو كتاب الكون وبكل ما فيه من دروس وعبر، وذلك لنصل إلى مرحلة القدرة على إيجاد الكمال في الدنيا والدين، وتتحقق لنا الحياة الطيبة التي وعد الله بها الذين يعملون على أساس إيمانهم بها.
كما نلاحظ أن الشهيد القائد (سلام الله عليه) يكرر الحديث عن زين العابدين وسيد الساجدين ليبين للناس القدوة التي يجب الاقتداء بها واتخاذ سيرتها نموذجاً تهتدي به مسيرة حياتنا ومعالجة الامراض القاتلة التي تصيب النفوس وتقضي على زكائها وتتحول الروح عند الإصابة بها إلى نظم شيطانية تجعل صاحبها من الشياطين، كالعجب والغرور والتوقف عند مستوى معين من العبادة لله والعمل في سبيله، فها هو علي بن الحسين لايزال يطلب من الله أن يبلغ بإيمانه أكمل الإيمان، فهل ثمة أحد يرى أن بينه وبين زين العابدين نسبة في مكانة أو فضلاً في أي جانب من الجوانب؟
ثم يتوقف الشهيد القائد عند مواصفات المؤمنين الحقيقيين التي لا بد أن نسعى لتحصيلها كمؤمنين، وذلك باعتماد القرآن سبيلاً للتوصل إليها، إذ لا بد لأنفسنا أن تصطبغ بصبغته، وتتحرك وفقه، وتبنى على أساسه، موضحاً ثلاث صفات لانزال في طريقنا الإيمانية بعيدين كل البعد عنها، وهي:
1 ـ الخوف من الله والاضطراب الذي توجل له القلوب عندما يسمعون ذكر الله.
2 ـ زيادة الإيمان كلما تليت عليهم آياته فهم مع القرآن إذ يتخذونه زادهم ليزدادوا إيماناً، وكلما بادروا لتلاوته استفتحوا بدعاء ربهم أن يهديهم بكتابه ويوفقهم لفهمه ليزدادوا إيماناً.
3 ـ الاعتماد على الله والتوكل عليه والاستناد إليه مع الاستشعار لمعيته والإحساس الدائم بالقرب منه والاطمئنان إليه سبحانه. وهكذا يتبين لنا ضرورة الإلزام لأنفسنا أن نتثقف بثقافة القرآن التي من أبرز ما تعطيه لنا وتجعله شيئاً مسلماً به عندنا ومن القضايا المفروغ منها التي لا تحتاج لمن يذكرنا بها، إنها قضية الجهاد في سبيل الله.
إن لكل عامل من عوامل الالتزام الإيماني في جانب الاعتقاد والتصديق آثاراً مهمة، ونتائج مثمرة تنعكس على الواقع، وتعود على النفس بكل ما يحتاج الوقع إليه، وتحتاج النفس إليه من العزة والنصر والأمن والاستقرار والوحدة والقوة والمنعة والاكتفاء الذاتي والحرية والاستقلال، لكن شريطة تجسيد مستوى ذلك الاعتقاد القلبي والتصديق الداخلي بالانطلاقة العملية والحركة الجادة في تحمل المسؤولية والقيام بالدور تجاه دين الله وتجاه المستضعفين من عباده المظلومين والمقهورين في كل هذه الأرض، ليسود الحق على العالمين ويعم كل هذا الوجود، وينكمش ويزول وينقشع ويتبخر وينتهي الباطل بكل تبعاته وتأثيراته ونظمه وأنظمته وكياناته.
بهذا انبنت حركتنا وظهرت وجهتنا واتضح دربنا كمنتمين للدين ومبنيين على أساسه، وكمرتبطين بالله من خلال ارتباطنا بكتابه وبختام رسله، بل إن ارتباطنا برسوله الكريم يوجب علينا التصديق بكل الرسل والالتزام بكلمة الله التي جاؤوا بها جميعاً ومثل تمامها وعمقها وسعتها وكمالها رسول الله صلى الله عليه وآلة دعوةً ودولةً، تربية والتزاماً، جهاداً وعدلاً، قوة ورحمة، ثباتاً واستقامة، وهكذا سرى نور الرسالة المحمدية سريان الدم في العروق ليهب أموات الأحياء الحياة الحقيقية التي تنطلق بمن لزمها والتزمها وعرفها وسعا لتحصيل موجبات بقائها.
تنطلق به من حياة طيبة إلى حياة أطيب وأوسع، ومن أفق رحب إلى آفاق أكثر رحابة، وذاك حين نعيش مع الرسول والرسالة من خلال السير والانطلاقة التي تقوم على أساس التمسك بامتدادهما الحقيقي، الامتداد الذي يتحقق في من أوجب الله مودتهم وفرض سبحانه علينا ولايتهم.
وها نحن كيمنيين نلمس بركة هذا الالتزام ونعيشه يقيناً شاهدناه وعلمناه وقرأناه وحفظناه نقطة نقطة وفصلاً فصلاً وباباً باباً، لا من خلال الكتب والمطولات، وليس وفق ما احتوته وتضمنته شروحات وأسانيد الملاحم والمرويات، وإنما من خلال التجارب والأحداث، ومن خلال السماع للكلمة الصادقة وهي تنطبع بالخطوة الصادقة والحركة الصادقة، بهذا صارت الأرض ساحة احتشاد لتحقيق العبودية لله، كيف لا والشهيد القائد ومن بعده السيد القائد يقدمان لنا أسس امتلاك الرؤية التي تمكننا من الخروج من نفق الظلمات إلى فضاء النور، وجو إشراقة شمس الحقيقة في صبح فجره الاصطفاء والاختيار الإلهي وضحاه النصر والتمكين.
لقد أراد الشهيد القائد أن يعلمنا من خلال هذا الدعاء: أن الجندية لله لن تقوم بواجب تمثلها إلا تلك الذات، التي تظل دوماً حية حاضرة متحركة يقظة، ذات الروحية المطمئنة القوية المتيقنة الواعية التي لا ترضى بما هي عليه، ولا تنسجم مع ما هو عليه الواقع والناس، بل تعي أن الواقع مهما كان مظلماً وحال الناس مهما كان مأساوياً فلا بد وأن تعمل على تغييره، قدوتها في ذلك الإمام زين العابدين علي بن الحسين (عليهم السلام) الذي عاصر أمة هُزِمت وقُهِرت، أمة ساد فيها الظلم وعم الطغيان واتسع نطاق البطش والقهر والإذلال، فالنفوس محطمة والقلوب حزينة مقهورة والناس خائفة مذعورة من يزيد وأشباه يزيد؛ لكنه تحرك ليربي ويثقف ويعلم ويبني ولم يقبل بأن يكون هو ومن يبنيهم ويربيهم ويوجههم امتداداً للواقع المظلم، بل تحرك بنفس يملؤها الأمل وزرع الأمل الذي تعود بذرته ونبتته في أصلهما إلى القرآن، فبنى الإمام الباقر، المعني بحفظ امتداد خط الولاية والإمامة، وبنى زيداً الفقيه الثائر على الطاغوت، وبنى الكثير من الرجال الذين شكلوا في ما بعد أمة لا تزال تسير على طريق الجهاد وتعشق التضحية والاستشهاد جيلاً بعد جيل حتى اليوم.
ومن هنا نستوحي كعاملين في سبيل الله وفي ميادين الفكر والثقافة والتوعية والتربية والتعليم على وجه الخصوص ثم في بقية الميادين بصورة عامة ألا نكون في ما نقدم ونربي ونثقف منحصرين في نطاق واقعنا ومحدودين بحدود مشكلات وأحداث زماننا، لأنا بذلك سنصنع نفوساً في الجيل القادم نسخة مما عليه نفوسنا، بل لا بد من الحرص على تقديم الدين كاملاً، لا بد وأن نعلم الجيل الفتي كيف يكونون رجالاً، كيف يكونون جنوداً لله، وكيف يكونون أنصاراً لله يعملون على إعلاء كلمته، وأن ننظر بعين المستقبل ونتحرك بحركة الدين كله لنتمكن من الإحاطة بمعرفة الزمن كله.
وعلينا تتبع حركة الزمن وتفهم مجريات الأحداث واستيعاب ووعي ما اختزنه التاريخ على امتداد الصراع بين الحق والباطل، لنتحاشى ما وقع به المقصرون وضعيفو الوعي وناقصو الإيمان، وإن تحركوا تحت راية الإمام علي (عليه السلام) وتسموا باسم جند الله وأنصار دينه.
إن الإمام زين العابدين (عليه السلام) عاصر وعايش ما صنعه نقص الإيمان وضعف الوعي وقلة البصيرة، لذلك صدر دعاؤه بعبارة: «اللهم بلغ بإيماني أكمل الإيمان»، لأن ناقصي الإيمان هم الذين عانى منهم جده علي وعمه الحسن وأبوه الحسين (عليهم السلام)، فجده كان يعاني من هؤلاء الكثير ممن هم محسوبون على الحق وداخلون في نطاق المعدودين من جند الله، وبرغم كثرة عبادتهم التي بلغت حداً جعلها مرتسمة على جباههم وبارزة في سيماهم فهم التالون للقرآن كثيرو الركوع والسجود، لكنها عبادة تقوم على جهل، لهذا سقطوا عند أول شبهة واجهتهم في «صفين» عندما رفعت المصاحف من قبل جند النفاق بقيادة معاوية.
ليست فقط عوامل قوة الباطل لدى بني أمية وغيرهم من سلاطين الجور وقوى الاستكبار هي التي مكنتهم من التحكم بمصير الناس، بل إن تخاذل أهل الحق وتقصيرهم وضعف وعيهم هو العامل الوحيد في قوة الباطل واتساع دائرته.
لذلك علينا أن نعرف أن تخاذل المحسوبين على الحق والداخلين ضمن صف الحق هو أساس قوة الباطل وعمود سيطرته وغلبته، ويكفينا لو أننا نستوعب هذه الكلمة للشهيد القائد (رضوان الله عليه) حيث يقول: «حالة الانكسار والضعف هي حالة يصنعها ضعف وعي من ينطلقون للعمل، وإن كانوا تحت راية علي (عليه السلام) ويحملون اسم جنود الله وأنصار الله، لأن وعيهم قاصرٌ وإيمانهم ناقصٌ».