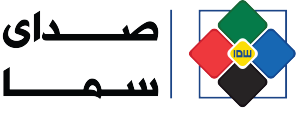طاعون الاضطراب

 الدكتور سيد مهدي حسيني، الحاصل على دكتوراه في العلوم السياسية
الدكتور سيد مهدي حسيني، الحاصل على دكتوراه في العلوم السياسية
إن كون شريحة من الجيل الجديد، من خلال محركات البحث والمعرفة السيبرنيتيكية، وبما يتناسب مع أعمارهم، تُبدي سلوكًا غير متزن، وللأسف تختار الشارع مسرحًا للتعبير عن مطالبها، ليس أمرًا مستغربًا كثيرًا. غير أن المثير للدهشة والمقلق حقًا هو سوء تدبير بعض القائمين على السلطة من ذوي النزعة التجارية من جهة، وتداعيات التحول الرقمي والدور الوظيفي للصدمات الإلكترونية من جهة أخرى، التي تلقي بالمجتمع الإيراني العزيز بين الحين والآخر في أتون الاضطراب والفوضى، وتقرّب خطر اندلاع حربٍ حضرية.
في الأساس، يمكن توصيف القرن الحادي والعشرين بوصفه قرن الصراع الجذري بين السلطة الحديثة والسلطة التقليدية في المجتمعات الانتقالية. وفي خضم هذا الصراع، يواجه مفهوم «العيش الكريم» قبل كل شيء أزمةً في المعنى. وفي هذا السياق، إذا كان للتمرّد أن يجد فلسفة، فلن تكون سوى فلسفة الجهل المحسوب والمخاطرة.
وعليه، فإن اشتعال النار تحت الرماد، وتفشي طاعون الاضطرابات على نحوٍ متكرر، وإلقاء المجتمع في هاوية أزمات دورية من طراز جديد، يتطلب تأمّلًا وتحليلًا ظاهراتيًا.
وفي هذا الإطار، فإن استعارة «الطاعون» من ألبير كامو، الحائز على جائزة نوبل في الأدب عن روايته الرمزية التي تحمل الاسم نفسه، والاستشهاد بإحدى عباراته، قد يكون كافيًا:
«في خضم هذا الضجيج، تصبح الممارسة المنظّمة للعنف أو الصمت المفروض، والحسابات الباردة أو الكذب المتواصل، قاعدة لا مفرّ منها.»
وبوجه عام، لا يمكن فهم أي ظاهرة اجتماعية معقدة دون إدراك الآليات النفسية الكامنة في جوهرها. إن اتساع نطاق الفوضى، وحدوث مجازر غير مسبوقة، وفرض تكاليف خيالية، يدل على النتيجة الناجحة لتجارب متكررة في مكر الإيحاء عبر صفحة الويب المسطّحة، والتي تسللت إلى جميع جوانب الحياة وشؤونها، الأمر الذي أطمع العدو الخبيث.
إن التباطؤ في إيجاد الحلول يشجّع المحتالين على ركوب الموجة الاجتماعية الناجمة عن قصور معرفة الجيل الناشئ بحقيقة وطبيعة العالم الرقمي، إلى جانب الشعوذة الإعلامية.
هذا الأمل الواهم يؤدي إلى إحداث قطيعة عميقة بين السلطة والتطبيق العملي لمبادئ الحوكمة الدينية، وهي قطيعة لا يمكن لأي موعظة أن ترمّمها.
كما أن التوقف في عطلات التاريخ من قبل القائمين على التربية والتزكية والتعليم لا يمكن تبريره بأي حال. وأحد الحلول يتمثل في تعريف الجيل الجديد بالطابع الجانوسي للظاهرة الرقمية. ووفقًا لأساطير اليونان القديمة، نُقش وجه يانوس، الملك الأسطوري القادر على استبصار الماضي واستشراف المستقبل بوضوح، على العملات الرومانية. وهذه الشخصية ذات الوجهين—أحدهما ينظر إلى الأمام والآخر إلى الخلف—تمثل اليوم، في الأدبيات السياسية المعاصرة، الوظيفة الجوهرية للرقمية.
لا يخفى أن منجزات الظاهرة الرقمية ووجهها المشرق والمتلألئ تنطوي على منافع لا تُحصى، وأن العمل العميق الذي أنجزه مهندسون عابرون للسياسة، على الأقل منذ عام 1940، يستحق كل التقدير. غير أنّه ووفقًا لرواية شائعة، فإن الوجه المظلم للرقمية يشبه قطًا يصطاد فأرًا ويلتهمه، لكنه—للأسف—يتظاهر بأن ما قام به كان لخير الفأر وصلاحه، بل وينظّر حتى لمساواة جميع الوحوش، والأسوأ من ذلك أنه يرفع الدعاء إلى إله جميع الحيوانات.
ومن خلال فهم الرجّة الناجمة عن طاعون الاضطراب الرقمي الأساس، تتضح بصورة أشدّ الخطوط الزلزالية التي بدأت تظهر تدريجيًا منذ دخول الإنترنت إلى إيران عام 1372هـ.ش (1993)، بين أفكار ودوافع الطبقة الناشئة حديثًا من جهة، وبين مُثُل الآباء وأوامر الحوكمة الدينية من جهة أخرى.
وأحد العوامل الرئيسية ذات الأثر المعنوي العميق هو الغلاء المخيف، الذي سيزيد المشهد تعقيدًا، إلى حدّ قد تختلط فيه في المستقبل المنظور «صرخات المظلومين والمحرومين بصوت خطوات “الأثرياء” الغاضبين الساعين إلى الابتعاد عن مجتمع الفقراء».
والحقيقة المؤسفة هي أنه في المرحلة ما بعد الحرب، وكذلك في الاضطرابات الأخيرة، ازداد تعقّد حياة الفئات المحرومة، وكأن أقليةً متميزة قد التقطت ثمار ذلك الهجوم وهذا الاضطراب، ووضعت فكر وروح الطبقة المستضعفة بين شفرتي مقصّ حاد.
«إن اللامساواة تغذّي تناقضات عميقة جدًا. وفي هذه المرحلة من التقدم العلمي، يصبح تطور الفكر والثقافة مستحيلًا.»
إن الأثر الأثيري لاستمرار هذا الوضع على العيش الكريم سيكون انفجاريًا وكارثيًا في سجل تاريخ الغد.
وبعد نجاح الشعوذة الإعلامية في توجيه بوصلة أفكار شريحة من الجيل الناشئ، وظهور فوضى المدن، واندفاع الجهلة كاسري الأعراف والآداب، يمكن القول بثقة إنه ابتداءً من عام 2026 فصاعدًا، لن يتحقق الفهم العميق والاستيعاب الأوضح لمعاني الظواهر والأحداث الاجتماعية وتداعياتها إلا عبر وسائل الإعلام، فيما ستتراجع سائر المصادر إلى الهامش.
«لوسائل الاتصال الجماهيري وظائف اجتماعية لا تقل أهمية عن وظائف المدرسة.
فهي لا تنشر المعلومات فحسب، بل تعمل أيضًا على توحيدها ومعيَرتها.
كما تُوجد تجارب جديدة ومتنوعة، وتزيد من الحراك الاجتماعي، وتؤدي في النهاية إلى وحدة عاطفية ومشاركة سياسية.»
وعلى الرغم من المهارة المدهشة التي يتمتع بها الجيل الناشئ في استخدام الإنترنت، فقد أظهرت اضطرابات العصر الجديد أن الجهل بطبيعة الظاهرة الرقمية ووجهها الجانوسي قد أصبح بالغ الخطورة. وقد اعتُبر التعليم دائمًا «عاملًا قويًا وموثوقًا في التحولات الثقافية والنفسية». ومع دخول الإنترنت إلى إيران عام 1372، وإهمال تعليم آثاره الثقافية، باتت مجهولية ماهيته واضحة في جميع الاضطرابات التي شهدتها السنوات الأخيرة.
إن تجلّي الجاهلية الحديثة في هذه الاضطرابات قد أفرز، في شهر يناير من العام الميلادي الجديد—والذي يحمل اسمه أصلًا من «يانوس»—شكلًا جديدًا من «قساوة الذئاب المتأنسنة ضد الإنسان الحديث»، فضلًا عن عنفٍ أشدّ غرابة مما يُمكن التعبير عنه بالكلام! …
إن مجموع هذه البنية السلوكية وهذا النمط المستحدث من العنف، ولا سيّما الجرأة على انتهاك الحرم القدسي لأهل بيت العصمة والطهارة (ع) في مدينة دزفول، عاصمة المقاومة في إيران، يفرض على المنظمات الثقافية العالمية، مثل اليونسكو، أن تكفّ عن الاكتفاء بالمشاهدة. ويجدر بـ أحد المخضرمين في ساحة السياسة الثقافية أن يوجّه نداءً صارخًا إلى العالم:
«ما دامت حضارةٌ ما، استنادًا إلى المواهب التي أودعتها الطبيعة والتاريخ لديها، تُهمل حقّ الآخرين وتلجأ إلى الضغط السياسي والفكري والأخلاقي، فلا يمكن الأمل بسلامٍ للبشرية؛ إذ إن نفي الخصائص الثقافية لأيّ شعب هو نفيٌ لكرامته واعتباره.»
يبدو أن المعرفة الإلكترونية قد مكّنت، بغير حقّ ولأسباب قابلة للنقاش، مالكي هذه القوة وروّادها من اغتصاب موقع السيادة على العالم.
في مطلع القرن العشرين، كان بعض المفكّرين يرون أن عوامل مثل وسائل الاتصال، والسكان، والصناعة تُعدّ عناصر حاسمة في تحديد القوة. غير أنّه مع استمرار «حرب العقول» وظهور اختراعات من قبيل «الحرب المعرفية/الناعمة غير القاتلة»، بدأ وابل من الأفكار الجديدة بالهطول، ليُحقق—من خلال التكنولوجيا فائقة الدقة—أعجب أحلام الخيال لدى الحالمين. …
الخلاصة:
إن الوصف البليغ الذي قدّمه جلال آل أحمد لكتاب الطاعون لألبير كامو يمكن أن يساعد على فهمٍ أعمق لطبيعة طاعون الاضطراب:
«الطاعون قصة مدينة في شمال أفريقيا؛ لا يُعرف لماذا ولا من أين يتسلّل إليها الطاعون. الناس يُصابون ويموتون…
تُفرض العزلة على المدينة، وداخل الأسوار الموبوءة يكون لكلّ واحدٍ من أهلها سعيه الخاص: هذا يبحث عن مهرب، وذاك يفتّش عن المخدّرات، وآخر يتتبّع سوقًا مضطربة. في مدينة كهذه، وإلى جانب سطوة الموت ومحاولات الإنسان اليائسة للفرار منه، والحزن الذي يخيّم كغبارٍ في الفضاء، فإن أكثر ما يلفت النظر هو أن حضور الطاعون—هذا العفريت القاحل—لم يفعل سوى تسريع خُطى كلّ فرد في الطريق الذي كان يسلكه من قبل. سواء أكان ذلك الطريق حقًا أم باطلًا، أخلاقيًا أم لا أخلاقيًا، فإن الطاعون لم يُبعد أحدًا عنه، بل دفعه بقوةٍ أكبر في الاتجاه ذاته. الطاعون عند ألبير كامو هو الميكانيكية؛ قاتل الجمال والشعر والإنسانية والسماء.»
(الغربزدگي، ص 186)
حقًّا، إن هذا المسار كفيل بأن يُزلزل ضمير الإنسان الحديث. فمع أنّ الوقائع الاجتماعية تشبه برادة الحديد التي تتخذ الشكل الذي يفرضه ضغط المغناطيس تحت الصفيحة المعدنية، إلا أنّ ما لا يدركه الروح والفكر لا يُكتشف بالرافعات والبراغي، والعقدة التي تُحلّ باليد لا ينبغي أن يُلجأ فيها إلى الأسنان.